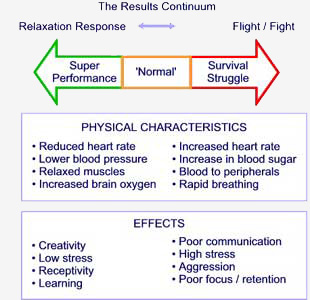11 سنة مرّت على 11 سبتمبر 2001، تاريخ حدث هزّ كما يبدو الوعي الجماعي العالمي و لم يقعده. و أتاح استعمال مصطلح الإرهاب في قالب معيّن.
و لكن بعيدا عن التعبئة الإعلامية الممنهجة لهذه الكلمة، ما هو الإرهاب في معناه اللغوي المباشر؟
قد ترهبك الاستعمالات المتعددة لهذه الكلمة، و لكن الإرهاب هو ببساطة “إثارة الخوف”.
و أنت تنظر فيمن حولك من الكائنات البشرية ستلحظ أن المحرّك الأساسي لغالبيّتهم هو الخوف. دعنا نفصّل هذا بعض الشيء.
في المجال الذاتي مثلا، أغلب البشر يخافون من سبر أغوار أنفسهم و يخافون من ارتكاب الأخطاء و يخافون من النجاح و من الفشل في آن واحد، بل إنهم في الواقع يخافون من الخوف نفسه، فيزدادون خوفا.
أما في مجال الصحة الجسدية، فتجد أن غالبية الناس يذهبون للتداوي و هم في حالة خوف من الأمراض التي أصابتهم و من الأمراض التي يمكن أن تصيبهم و قد تلحق بهم الأذى و الموت. و يأكلون خوفا من أن يجوعوا، و يجوعون خوفا من أن يسمنوا.
و في مجال العلاقات المقرّبة، فإن غالبية الناس قد يبقون بدون ارتباط عاطفي خوفا من أن يرتبطوا بالشخص الغير مناسب أو خوفا من أن يفقدوا حريتهم بالارتباط، و قد يرتبطون في علاقات حميمية خوفا من النقص في الإحساس بالحب، و غالبا ما يتزوّجون خوفا من أن يبقوا بدون أي زوج يهتم بهم و يوفّر لهم ما يحتاجونه. و ينجبون خوفا من أن يبقوا بدون سند قرب الموت أو وريث بعد الموت، و لا ينجبون خوفا من أن يكون خليفتهم مشوّها خلقيا أو ذهنيا أو عاطفيا أو عاطلا مهنيا أو اجتماعيا..
و فيما يخص باقي العلاقات الاجتماعية، فكثير من الناس يخافون و يحذرون من الآخرين و من الانخراط معهم في تفاعلات أغلبها سيقوم حتما على الغش والوصولية و التحايل و الاستغلال و قلّة الثقة، و غالبا ما تنتهي بالعراك و العنف و الاغتصاب..
و في المجال المهني و الدراسي، تجد كذلك أن غالبية الناس تعمل و تدرس خوفا من أن لا تحصل على الشهادة كباقي الناس و المكانة الاجتماعية و الممتلكات المادية و المهنة التي توفّر لهم كميّة الأموال التي يظنون أنها لازمة لهم.
في المجال المالي أيضا، غالبية الناس تخاف من أن لا تتحصّل على الأموال التي يظنون أنها ستكفيهم و ستسعدهم. كيف لا يخافون و البلاد و كل العالم في أزمة اقتصادية و مالية خانقة و الأسعار في ارتفاع مستمرو البترول في تناقص مستمر؟
أما في المجال الروحي فحدّث و لا حرج. معظم المتديّنين ستجدهم في أحسن الحالات يلتزمون بسلوك ديني معيّن خوفا من عقاب قد يسلّطه عليهم إلاههم الغاضب أبدا و الحانق و المتجبّر، و في أكثر الحالات هم ملتزمون بذاك السلوك خوفا من أن يفقدوا منزلة اجتماعية ما أو خوفا من عقاب و غضب رجال الدين و أشباه رجال الدين و بقية الوسطاء الدينيين.
دوّامة الإرهاب هذه هي غير جديدة على الوعي الإنساني. و هي لم تنتظر حدثا يتمّ الترويج له كما لو أنه الحدث الأكثر إرهابا في تاريخ البشرية. نحن نحيا وعي الإرهاب منذ زمن بعيد.
كيف كان لحدث 11 سبتمبر 2001 أن يكون دون أجهزة التلفاز و الاستعراض الإعلامي الذي رافقه و لحقه؟ كان يمكن أن يمرّ عاديا و مقبولا في نظر الناس مثلما تمرّ كثير من عمليات التفجير و القتل و الحروب في العالم، و غير ذلك من طرق الإرهاب الصحي و العاطفي و الفكري و الاجتماعي و المالي و الديني و البيئي في حياة كل إنسان.
و لكن ما السبب في إثارة هذا الكم الهائل من الخوف؟
في الواقع، فإن المتسبّب الأول في هذا الإرهاب هو “الأنا”. أجل. إنه أنا و أنا-ك و أنا كل إنسان غير مدرك لكينونته الكاملة.
و ما هو الأنا؟ يمكن أن نختصر تعريفه في أنه جهاز النجاة من الموت –أو جهاز البقاء على قيد الحياة. يقوم هذا الجهاز بتشغيل الآليات الدفاعية المتاحة له على غرار الخوف و الشك و القلق و الغضب كلّما استشعر خطرا يهدّد حياة الإنسان. ما من مشكل خاص في هذا الجهاز. فهو فعّال و مفيد في حالات الخطر الحقيقية. تخيّل مثلا أني أحاول أن أدفع بك من على سطح بناية شاهقة. سيتفطّن أناك للهلاك و سيجعلك تحس بالخوف و ستبتعد لإنقاذ نفسك بشكل أوتوماتيكي. المشكل هو عندما نمكّن هذا الجهاز من السيطرة على وعينا بحيث أنه يجد في كل تحد خطرا، فتكون الأخطار التي نخاف منها هي غير حقيقية. ما من مشكل في الخوف في حد ذاته. فهو آلية دفاعية لاأكثر و لا أقل.
باختصار، فإنك عندما لا تتحكّم في أناك، فإنه هو من سيتحكّم فيك.
ما يرهب الناس في أغلب الأحيان هي أخطار غير حقيقية، و هي تعطّل حياتهم و تستعبدهم أكثر مما تحميهم من الهلاك. بل إنها هي ما يقودهم إلى الهلاك.
ما يرهب الناس في واقع الأمر هو الاعتقاد السائد بالقلّة و الندرة. النجاح صعب بل و مستحيل. الثقة بالنفس هي مسألة مثالية. الصحة الجيّدة و الجسد الرشيق أشياء خيالية و تتطلّب كثيرا من المال و الوقت و المشقـة و الجهد و العناية و المعرفة غير المتوفرة حاليا. الأزواج الطيّبون والأبناء الصالحون و الأصدقاء الحقيقيون هم عملة نادرة. عروض الشغل غير متوفّرة بسبب الأزمة الحادة. و الدراسة تحتاج إلى تضحيات جسيمة و مرهقة و الشهادة لا تنفع في سوق الشغل في النهاية. ضخُ المال يخضع إلى توازنات مالية معيّنة و هو يعمل لصالح فئة قليلة تتحكّم في كل شيء. أما عن الله فإنه قد افتقد الرحمة منذ أن أنزل بآدم و حواء إلى الأرض و هو يضيّق بشدّة على كل إنسان لا يتّبع الصراط الذي اختاره له الوسطاء الدينيون.

هذه الاعتقادات قد تبدو حقيقية للكثير من الناس لأنهم آمنوا بها، و لذلك فهي تتحقق لهم فعلا. و على الرغم من أنها تعطّلهم في حياتهم فإنهم عن غير وعي يواصلون الإيمان بها.
كيف نتخلّص من الإرهاب الذي نفرضه على أنفسنا إذن؟
يكون ذلك بالتماهي و الانسجام أكثر مع الحقيقة.
و من بين الطرق المتاحة لتحقيق هذا هي بتغيير الاعتقادات الخاطئة التي نؤمن بها. و كخطوة أولى لا بد من استكشاف المعلومات و المعارف الجديدة الأكثر قربا للحقيقة و التي تخرجنا من حالة الاستسلام و منطقة الراحة.
هل تعلم مثلا أن 99.999999% من الكون-و بالتالي من جسدك و من السيارات و من الأوراق المالية و المنازل و باقي الناس- هو فراغ متكوّن من الطاقة؟ و أن 0.0000001% الباقية من الكون- و التي نراها فنسمّيها مادّة- هي في واقع الأمر فوتونات ضوئية-أي طاقة أيضا- تخرج و تدخل إلى مجال رؤيتنا بمعدّل 1.000.000.000.000.000.000.000 مرّة في الثانية؟
ما من عالم فيزيائي على الإطلاق. إن هو إلا حلم. و حيثما توجّه طاقتك فإنك ستحقّق تماما ما تريد.
و الآن هل تعلم أن هذه الفوتونات و هذه الطاقة تتصرّف حسب توقّعات الإنسان؟ و أن هذا الكون هو في تمدّد و تزايد؟ بكل طاقاته و فوتوناته؟
الكون وفير و كل ما تبحث عنه وفير.
الكون رهن إشارتك. رهن تفكيرك و شعورك و إيمانك.